حزب العدالة والتنمية المغربي: هل هي السقطة الأخيرة لتجار الدنيا والدين؟
على امتداد الرقعة الجغرافية التي تُوصَف عادة ب”العالم الإسلامي”، وفي عز الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، طرأ على ساحة الفعل السياسي مُكَوِّنٌ بَدَا وكأنَّه يملك الحل السحري لا لمشاكل الدنيا وحدها، وإنما لمآلات الآخرة أيضا.
كان الصراع على الصعيد الكوني قائما بين رأسمالية تزعم أن خلاص الإنسان في الحرية الاقتصادية والليبرالية السياسية، واشتراكية تعتبر أن خلاص الإنسان هو عينُه الخلاص من شرنقة الاستغلال التي وضعته فيها الرأسمالية. وفجأة خرج مَنْ يدعي أن الخلاص ليس في هذه ولا في تلك وإنما هو في العودة إلى “الدين” وإقامة “دولة الخلافة”.
وانتشرت كالفِطَر كُتُبُ سيد قطب، وحسن البنا، ويوسف القرضاوي وغيرهم. وظهرت جماعات المُلتحين في الشوارع والجامعات وبدأت تختفي تدريجيا كل مظاهر الحداثة التي كانت شعوب المنطقة قد اكتسبتها خلال الحقبة الاستعمارية: حرَّمُوا الموسيقى وتوعدوا كل مَنْ يسمع أغنية بصب الرصاص المُذاب في أذنيه يوم القيامة. وجَرَّموا ارتداء التنورة وحَجَبُوا المرأة وراء الأقمشة السوداء ووعدوا كل “متبرجة” بأن يتحول شعر رأسها إلى ثعابين في جهنم، و ـ باختصار! ـ فقد حرَّمُوا وجرَّموا كل ما هو جميل من النحت والرسم إلى تعلَّم “لغة الكفار”.
وباسم “الجهاد” حمل الإسلاميون السلاح في ساحات القتال ضد “الكفرة الشيوعيين”، بتأطير من المخابرات الأمريكية، في أفغانستان. وعملاً بالمبدأ الفقهي القائل “حيثُما كانت المصلحة فتم شرع الله” بايعوا جعفر النميري في السودان قبل أن ينقلبوا عليه. وفي إيران ركبوا على الثورة التي صنعها الشيوعيون واستولوا عليها، وعلى نظام الحكم بعدها، ثم علقوا “الكفار الشيوعيين” على المشانق ومزقوا صدورهم بالرصاص على أعمدة الإعدام.
● سوطٌ في يد الأنظمة وأداة طيعة في يد الرأسمالية العالمية.
ودون أن نسرد هنا كل المآسي التي صنعها “الإسلام السياسي”، والتي لا يتسع لها المقام في كل الأحوال، فالخلاصة التي يؤكدها تاريخ القرن العشرين برمته هي أن “الإسلاميين” كانوا على الدوام أداة طيعة في يد الرأسمالية العالمية التي وظفتهم في محاربة المد الشيوعي داخل “العالم الإسلامي”، مثلما كانوا السوط الذي جلدت به الأنظمة الرجعية في المنطقة كل القوى المطالبة بالعدالة الاجتماعية وبالتوزيع العادل للثروة. وفي تلك المعركة القذرة التي خاضها “الإسلاميون” ضد تطلعات الشعوب نحو الحرية والديموقراطية والحداثة ظلوا يتظاهرون ب”الطهرانية”، ويُبَخِّسُون الدنيا في أعيُن الناس، ويَعِدُونهم بنعيم الآخرة، ويتوعدونهم بجحيمها. وتناسلت كُتُب “عذاب القبر” و”الثعبان الأقرع” في الأسواق، وذاعت الأشرطة التي تتوعد كل “مارق” بالعذاب الأليم، وتُمنِّي كل خَنُوعٍ بالنعيم. وكانت النتيجة هي انتشار الخرافة وانسحاب الجماهير العريضة من ساحة المواجهة مع قوى الاستبداد والاستغلال والرجعية.
ربما هو مكر التاريخ الذي شاء أن يتزامن انهيار الاتحاد السوفياتي مع دخول “العالم الإسلامي” عصر انتشار الفضائيات. وما أن احتلت الهوائيات المقعرة سطوح وواجهات البيوت حتى انهمرت القنوات التي تولت، بشكل أو بآخر، نشر ثقافة “الإسلاميين”، وظهر القرضاوي وأمثاله من شيوخ التضبيع، وانساقت وراءهم القُطعان. وشيئا فشيئا اختفى اليسار الذي كان يشكل إطارا يحتضن مطالب الفئات الأكثر حرمانا داخل مجتمعات “العالم الإسلامي”، وتلاشت النقابات، وتغوَّلَت الرأسمالية وذيولُها، وتم الدوس على مكتسبات الفئات المظلومة وحقوقها أكثر من أي وقت مضى. وقاد كل ذلك إلى اتساع الهوة بين الثراء الفاحش والفقر المذقع. وبينما كانت قوى الاستبداد والاستغلال تُجْهِزُ على آخر مكتسبات وحقوق العمال والموظفين وباقي الفئات الوسطى والدنيا كان “الإسلاميون” يجدُّون ويكدُّون في نشر الخرافة، والإمَّعِيَة، وثقافة الانقياد. وحتى حين خرجت الجماهير إلى الشوارع سنة 2011 فقد امتطى “الإسلاميون” انتفاضات “الربيع العربي” لكي يصلوا إلى السلطة أو إلى المشاركة فيها. وفي الحالتين معا كانت النتائج كارثية.
لم تقُم دولة الخلافة المزعومة التي ظل “الإسلاميون” يبشرون بها. وحتى حين قام ما قيل إنه كذلك، في جزء من سوريا والعراق، فإنه انهار تحت ضربات السوخوي الروسية دون أن تنقذه “طيرٌ أبابيل” ودون أن يُنزل الله لنُصرَته جنودا “لم تروها”. وحين تدخل الجيش لإنهاء حكم “الإسلاميين” في مصر وخرج محمد مرسي العياط من القصر إلى الزنزانة لم تُزلزل الأرض ولا انشقت السماء. وحتى حين اعتصم أنصارُه في “رابعة العدوية” وقال لهم شيوخ الخرافة بأنهم شاهدوا “جبريل” يأتي لنصرتهم في الفجر فلم يأتهم، قبل الفجر بقليل، سوى رصاص القوات الخاصة. ثم انتهى الأمر بجماعة “الإخوان المسلمين” إلى الحظر وإغلاق المقرات ومصادرة الممتلكات. أما في تونس فقد اضطر “الإسلاميون” إلى الاعتراف بقوة الواقع وانخرطوا (مُكْرَهين طبعا لا أبطالا!) في مشروع الدولة المدنية حتى أنهم لم يقاوموا مشروع قانون المساواة في الإرث. وفي المغرب، وبعد ما يناهز ثمان سنوات من قيادة “الإسلاميين” للحكومة، فإن البلاد توجد على حافة انفجار اجتماعي ينذر بقيادتها إلى المجهول. ولم تظهر إنجازات “الإسلاميين” بقدر ما ظهر استغلالهم لمناصبهم في مراكمة الثروات، وتكريس المحسوبية والزبونية، وضرب مكتسبات الجماهير الشعبية التي وعدوها بما لم تعد به ليلى قَيْسَهَا ولا بُثَينَةُ جميلَها. كما لم تظهر منهم “الطهرانية” المزعومة ولا الزهد المُدَّعَى في الدنيا ومتاعها. بل سرق بعضهم زوجات بعض، واقتنوا الفيلات والسيارات الفاخرة، وكان منهم مَنْ قال إنه يريد اقتناء هيلوكبتر. ولم تظهر منهم “العفة” وإنما ضُبِطُوا متلبسين ب”الفاحشة” على عتبات الشَّفَق.
● فشلٌ سياسي، وإفلاسٌ أيديولوجي، وانفضاحٌ أخلاقي.
نعم، هذه هي حصيلة “الإسلاميين” في كلمات معدودة: الفشل السياسي، والإفلاس الأيديولوجي، والانفضاح الأخلاقي. وبالاقتصار على الحالة المغربية يحق لنا، في ضوء كل ما سبق، أن نتساءل: ألم يئن الأوان ليعود “الإسلاميون” إلى المساجد والزوايا ودور القرآن ليهتموا بالوضوء والتيمم وغسل الجنابة ودم الحيض والنفاس ويتركوا السياسة لأهلها؟
إن واقع المغاربة اليوم اجتماعيا أسوأ بكثير مما كان عليه حتى في زمن سياسة التقويم الهيكلي، وفي عهد تلك الحكومات التكنوقراطية أو التي كانت تقودها “الأحزاب الإدارية”. فآنذاك كان المغربي يشكو من ضيق مجال الحريات، ومن الرشوة، ومن الفساد الإداري. لكنه كان ـ على الأقل ـ يجد سبيلا إلى النزهة في نهاية الأسبوع، ويمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويتبضع، ويراوده حلم بناء بيت وامتلاك سيارة دون أن يتحول إلى فريسة بين مخالب وأنياب الأبناك. أما اليوم فالموظفون في السلالم العليا لا يُكملون الشهر إلا بالقطاني و”القطاني (تتمة)”. والبسمة غادرت الوجوه وأصبحت، وأنت تسير في الشارع، ترى وجوه الناس عابسة مكفهرة من فرط الإحساس بالغبن. وبدل أن يكون المغرب قد استمر في أفق الإصلاح الذي فتحته حركة 20 فبراير قبل سبع سنوات، ويذهب في اتجاه ترسيخ المؤسسات، والحداثة، وبناء الدولة المدنية، وإقرار المساواة التامة بين النساء والرجال…إلخ، ويعتني بالجانب الاجتماعي من حياة المواطنين، فقد كانت السنوات السبع عِجَافاً على عموم الشعب، وسِمَاناً على “الإسلاميين” الذين أصبحوا يذهبون لممارسة العشق في باريس، بينما المواطن المغربي لا يجد فرصة للاصطياف في شواطئ بلاده لأن عليه أن يواجه في نهاية الصيف مصاريف الدخول المدرسي وعيد الأضحى وغيرها من اللازم ولازم اللازم. وبينما تتراكم الملايين في حسابات “الإسلاميين” الأصفياء الأتقياء، الزاهدين في متاع الغرور، تتراكم القروض البنكية على مختلف فئات المأجورين وتهدد بعضهم بالطرد من بيته، والآخر بفقدان سيارته، والثالث بأمراض القلب والشرايين.
● كابوس ثقيل على الجميع!
وفي الحالة المغربية، بالضبط، شكَّل “الإسلاميون” كابوساً ثقيلاً على الجميع. بدأوا تاريخهم باغتيال عمر بنجلون اليساري وتوَّجُوه متهمين باغتيال بنعيسى أيت الجيد، اليساري أيضاً. وكما هدد فصيل منهم الملكية في السبعينيات ب”الطوفان” قام قيادي منهم في السنة الماضية ليعلن أن الملكية عائق أمام التنمية. وبعد أن هدد زعيمهم، صاحبُ العفاريت والتماسيح، أثرياء البلد بفرض ضريبة على الثروة انتهى به الأمر إلى فرض اقتطاعات جديدة، وقاسية، على المأجورين. وليست الأمثلة عن ثقل كابوس “الإسلاميين” على الحياة السياسية والاجتماعية هي ما ينقص في كل الأحوال. فوجودهم خرَّب الجامعة المغربية وأفرغها من زخمها السياسي عبر ضرب الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وخرَّب النقابات التي تسللوا إليها وحولوا بعضها إلى أذرع لتنظيماتهم، وحرَّض الجماهير على معاداة قوى الحداثة والتقدم، قبل أن يُحرِّضَ على الملكية نفسِها ويُصوِّرَها للناس كعائق أمام التنمية، أي كعائق أمام طموحاتهم المشروعة في آخر المطاف. وهكذا فهم يُخربون، في النهاية، كل ما بناه المغاربة منذ جيل الحركة الوطنية إلى جيل 20 فبراير.
وبذلك يعلن “إسلاميو” المغرب أيضا التحاقهم بركب الفشل والإفلاس والانفضاح. وخارج المغرب يبدو “الإسلاميون” وقد فشلوا فشلا ذريعاً في كل مكان. وحتى في إيران (التي قد يتباهون بها) فهم لم ينجحوا سوى في جر البلاد والشعب إلى سباقات مُنْهكة وإلى عزلة دولية خانقة. أما في تركيا فسيكون من الغباء الادعاء بأن النموذج “الإسلامي” ناجحٌ هناك لأن الناجح هناك فعلا هو العلمانية التي استوعبت “الإسلاميين” وأوصلتهم إلى السلطة في ظل دستور علماني. أما الإسلام السياسي، الذي طالما أوهم القُطعان ب”الصحوة”، فهو الآن يحصد الهزيمة. وعليه أن ينسحب قبل أن يسقط السقف على الجميع.
-

وسط أجواء احتفالية أسطورية..ماكرون يفتتح دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”
في حفل تاريخي فريد من نوعه انتظم خارج الفضاءات المغلقة وامتد استعراض القوارب التي نقلت أعضاء 205 وفد رياضي مشارك... رياضة -
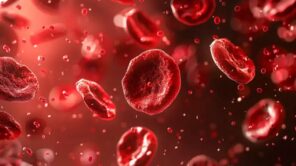
تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لتحديد مستويات الكريات البيضاء في الدم
تمكن علماء في روسيا من تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي تساعد على تحديد مستوى الكريات البيضاء في الدم بدقة عالية. وقال بيان... صحة -

سد النهضة.. الأمن المائي للسودان ومصر على المحك
دار الزمان دورته الجهنمية على مصر أم الدنيا وجارتها السودان العظيم فأصبحت هاتان الدولتان تحت رحمة العطش بفعل سياسات دولة... دولي -

مغني الراب “كادوريم” يعلن ترشحه لمنافسة قيس سعيد على كرسي الرئاسة في تونس
أعلن مغني الراب التونسي، كريم الغربي، المعروف باسم ''كادوريم''، مساء اليوم الجمعة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر... دولي -

في الهند.. ولادة طفل بـ 4 أذرع و4 أرجل ووجهين
هناك من يسميها تشوها خلقيا فيما يراها آخرون معجزة إلهية إلى من يصر على أنها مرض وراثي لكنها تحصل أحيانا... على مدار الساعة -

هايتي..اشتباكات أفراد العصابات مع قوات الأمن تخلف مصرع العشرات
لقي العشرات من أفراد العصابات مصرعهم، في ضواحي العاصمة الهايتية، خلال اشتباكات مع الشرطة الوطنية التي تسعى لاستباب الأمن في... دولي





